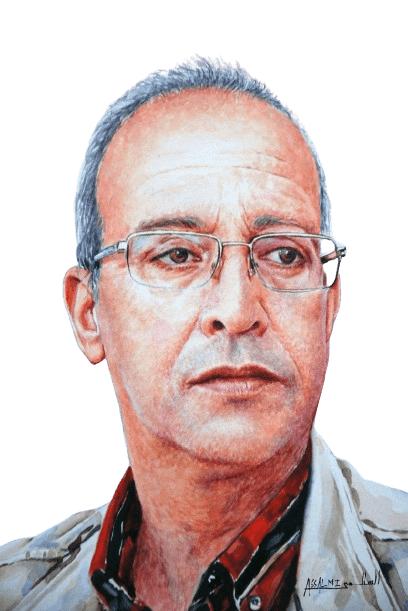“وحده من تعلم سلفا كيف يصمت، يكون قادرا على الكلام” جوزيف أنطوان دينوارت
على غرار ما قاله مارك توين من أنه قبل مائة عام كنت ميتا، قبل أن أولد، يمكن أن نقول إن الأصل في الإنسان هو الصمت قبل أن يتعلم اللغة ويأخذ حصته من الكلام، لكن المتأمل اليوم لما يعبرنا من خطابات وكتابات وتصريحات وأقوال في كل شيء وفي اللاشيء… سيحس أن الضجيج والثرثرة تكاد تؤدي الأرض وساكنيها، في الصحافة والسياسة في الأدب والثقافة، في الاقتصاد كما في الصحة والفن، ناهيك عن أطباء التغذية والكوتشات والخبراء بدون علوم ولا فنون، فمع فورة وسائط التواصل الاجتماعي، تم منح الكلام لمن لم يتعلم يوما فضيلة الصمت، أي بُعدُ التأمل والتبصر في الأمر قبل الإقدام على القول فيه والتحدث عنه، لا يتعلق الأمر بوجهة نظر في قضايا مختلف حولها بل بجزم من يمتلك وحده ناصية الحقيقة وغيره يتحدث بالباطل.
في مقابلة له مع صحيفة “لاستمبا” الإيطالية قال الفيلسوف والكاتب أمبرتو إيكو رأيه الشهير، في وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت “تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء”.
هل ما عبر عنه أيكو هو إحساس النخبة بموجة جديدة من المتكلمين أصبحوا ينافسونها في قول المحتبس في حناجرهم؟ هل هو ترفع عن العامة من الرعاع الذين أصبحوا الآن يصنعون بلاغتهم الخاصة للتعبير عن أنفسهم؟
قد يكون بعض هذا صحيحا، لكن يجب أن نعترف أن تعميم التعليم وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي وسهولة الولوج إليها، سمح لذوي غير الاختصاص أن يفتوا في الشيء ونقيضه، وقد لعبت وسائل الإعلام الجديد دورا كبيرا في منح الحق في الكلام لغير المعنيين به، لذلك امتلأت الساحة بالثرثارين وصانعي الضجيج والمؤثرين الجدد من صناع المحتوى الذين يغرقوننا في قلب التفاهة والروتين اليومي وإعطاء المكروفون لمن لا يفقه حتى السؤال المطروح عليه، والأخطر أن مس كل هذا الخبل مقاطع مهمة من النخبة من “الشعراء” و”الروائيين” والمغنين” وباقي المدعين من مؤسسي مراكز الخبرة والتفكير الاستراتيجي وتقنوقراط الحلول الجاهزة والمدعين من “التيكتانك” الذي يقولون الشيء ونقيضه بلا حسيب ولا رقيب، ببساطة لأنهم لم يتعلموا بلاغة الصمت قبل الكلام.
كان أجدادنا يقولون عبارات غريبة أجدها اليوم ذات دلالة كبرى ونحن في أمس الحاجة إليها، مثل يرجع لسانوا لفمو” أو “يتصنت لراسو”، أي اللجوء بين الفينة والأخرى إلى الصمت ليس جبنا ولا تواريا من معركة الإدلاء بالكلام الحق، ولكن التنصت للذات، أي التأمل والتفكر العميق قبل النطق، وكذلك عبارة “ماكاين معاينة” وهو تصغير للمعنى، فقدنا المعنى، وأصبح تتفيه كل شيء: السياسيين، الأبطال التاريخيين، الرموز الدافئة التي كانت مثل أساطير تغدي روح الأمة والأمل والقدرة على التحدي، من طرف معاول الهدم لم تستثن منارة كبرى في هذه الأمة، من كانوا بالأمس مثل منارات عالية في عتمة درب أمة، أصبحوا إما عملاء للاستعمار أو المخابرات الوطنية أو الأجنبية، أو متخلفين عن زمنهم أو فاسدين… مقابل الإعلاء من شأن التافهين واللصوص ومغنيات الكباريهات وعلب الليل اللواتي أصبح بعضهن مصادر خبر موثوقة لدى صحافيي الميكروفونات الملونة.
لمن نكتب اليوم؟ من يقرأنا؟ من ينصت لما نتفوه به؟
قد يكون هذا هو السبب في تراجع المثقفين المتنورين إلى الخلف، فالتيار أقوى، والفكر المتنور كما لو انطفأت ذبالته، أمام كل هذه الأفواه التي توضع أمامها عشرات الميكروفونات بلا صحافة، لترطن بالتوافه من الأمور وتخوض في الحياة الخاصة للآخرين وتقيم الدنيا وتشغل الناس بما تساقط من زاد الكلام..
لكن هل الصمت حل دائم؟
لا أتكلم عن مثقفي وإعلاميي الهميزات الجارين وراء الشهرة السريعة والمال العام، ولكن عمن يصنعون المعنى ويحمون روح الأمة، من لا يتكلمون إلا بعد صمت حكيم، علينا أن لا نترك كل هذا الضجيج يقتل ويدمر كل شيء حي فينا، إن الثرثرة لا تغير العالم وإنما تبقيه مشوشا، غير مسموع وغارق في ضباب ضجيج المتحذلقين الذين لا تنقصهم المعلومة فقط، بل الخبرة والدراية وقبل ذلك الحياء لأنهم لم يصمتوا قبلا ليتكلموا بجدية ويفيدوا مستمعيهم، وفوق كل شيء، لنكن صادقًين مع أنفسنا فقط. فبذلكَ لن نكون كاذبين مع أحد كما قال هاملت شكسبير.